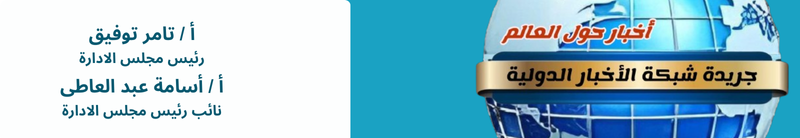بقلم / محمـــد الدكـــروري
الحمد لله الذي خلق الخلق بقدرته، ومنّ على من شاء بطاعته، وخذل من شاء بحكمته، فسبحان الله الغني عن كل شيء، فلا تنفعه طاعة من تقرب إليه بعبادته، ولا تضره معصية من عصاه لكمال غناه وعظيم عزته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلاهيته، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله خيرته من خليقته، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته صلاة وسلاما كثيرا، أما بعد فاتقوا الله تعالى بدوام الطاعات، وهجر المحرمات فقد فاز من تمسك بالتقوى في الآخرة والأولى، وخاب وخسر من اتبع الهوى ثم أما بعد ذكرت المصادر الإسلامية أن التدين ليس شيئا مدّعى، وليس بالزي وبالمظاهر، ولكنه تطبيق عملي، وهذا يقرر أيضا أن التطبيق للدين ليس في المسجد فقط، هو كذلك في المسجد، وهو كذلك في الزكاة والصيام والحج.
ثم هو أيضا في التعامل مع الآخرين لأنه لا يقبل في الإسلام أن يشاهد الرجل متهجدا في محرابه، بينما هو غاش في محراب الحياة، وإنما الواجب عليه أن يكون مطبقا لهذا كله في كل تعاملاته، ولذلك رتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخول الجنة على هذه الخصلة العظيمة، فقد روى الإمام أحمد عن يزيد بن أسد القصري، قال، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم “أتحب الجنة؟” وتأملوا هذا العرض النبوي والتعليم المصطفوي ما أجمله، إنه سؤال لو وجّه لكل أحد، فإن الجواب معروف تبتهج لأجله النفوس، وتشرئب الأعناق “أتحب الجنة؟” فالجواب من كل مسلم نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم “فأحب لأخيك ما تحب لنفسك” وتأملوا رحمكم الله هذا الوصف النبوي البليغ الموجز الشامل لكل شيء “ما يحب لنفسه” وفي الرواية الأخرى “من الخير” وهذه اللفظة كلمة جامعة.
تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية، وتخرج المنهيات لأن اسم الخير لا يتناولها، فعُلِم بهذا أن المؤمن هذا ديدنه، وهذا منهجه، يصبح ويمسي وهو يريد أن يؤدي هذا الحق نحو إخوانه، فهو يحب الخير لهم في أمورهم الدينية، وهذا هو أعظم ما يحب للآخرين، وهو الذي كانت عليه سنة النبيين أن يسدوا إلى أُممهم وإلى مجتمعاتهم دلالتهم على الخير الذي يقودهم إلى الله جل وعلا بالإستقامة على طاعته ومحاذرة معصيته، ثم أيضا يحبون للناس الخير في أمور دنياهم، وهذا يقتضي أن يكون هذا الباعث لدى الإنسان باعثا قلبيا، فهو في مشاعره إذا سمع بخير أُوتيه أحد من الناس، فرح به وهو يتمنى الخير للآخرين، كما أنه في ناحية تطبيقية عملية، يكون سببا للخير نحو الآخرين، لا يسعى لضرهم في شيء بأي طريقة كانت عملية أو قولية، فهو أيضا يسدي للآخرين الخير في أقواله وألفاظه وحديثه معهم.
ولو أن الناس تمثلوا هذا المنهج القويم، لكثرت الخيرات ولإزدهرت المنافع فيما بينهم، ولكن الشيطان ضيّق عليهم بأن جعل في قلوبهم أنواعا من الحقد والحسد، فأدى إلى كثير مما يشاهد من القطيعة والخصومات، عياذا بالله من ذلك، وكما ذكرت المصادر الإسلامية أنه جاء في صحيح مسلم عن النبي المصطفي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ” من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ” فتأملوا أيها الإخوة المؤمنون، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دخول الجنة والمباعدة عن النار، مبنيا على هذين الأصلين العظيمين الأول هو صلة الإنسان بربه وإيمانه به، والثاني صلته بالخلق، فهو أن يؤدي إليهم ما يحب أن يؤدوا إليه، وأن يكره أن يصرف ويؤدي نحوهم ما يكره أن يؤدوا هم إليه.
وفي الجملة ينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، وأن يكره لهم ما يكره لنفسه، فإذا رأى في أخيه المسلم نقصا في دينه، إجتهد في إصلاحه، وقال بعض الصالحين من السلف أهل المحبة لله نظروا بنور الله، وعطفوا على أهل المعاصي، ومقتوا أعمالهم، وعطفوا عليهم، ليزيلوهم بالمواعظ عن فعالهم، وأشفقوا على أبدانهم من النار، فلا يكون المؤمن مؤمنا حقا حتى يرضى للناس ما يرضاه لنفسه، وإن رأى في غيره فضيلة، فاق بها عليه، فإنه يتمنى لنفسه مثلها، ولكن دون أن يحسده، فهذا أصل عظيم ينبغي أن نستحضره في كل تعاملاتنا، وأن نتواصى به، وأن نعلمه أهلينا وأولادنا، وأن نكون مستقرين عليه “لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير”