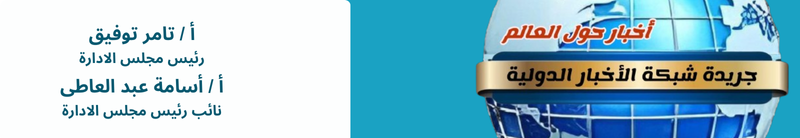د. حسين إسماعيل
كانت الساعة تقترب من الثانية بعد منتصف الليل حين دخل الرجل على كتفَي ولدين، كلٌّ منهما يمسك بطرف من بطانيةٍ رماديةٍ مشبعةٍ برائحة الديزل والغبار، كان الباب الزجاجي لمستشفى المدينة العام ينفتح ويغلق بصرير مبحوح، والشتاء على الرصيف يقرص وجوه الواقفين في مدخل الاستقبال، كانت الأرض مبللة بماء ممزوج بمطهر رخيص، والهواء محمّلًا بخليطٍ من أنينٍ مكتوم وكحة حادة وشتائمٍ تخرج متخفّية بين الأسنان
أنا الصيدلي النوبتجي تلك الليلة، اسمي يونس، أقف مكان عملي في نهاية ممر طويل، قبالة غرفة الطوارئ مباشرة، كأنهما عينان في جبهةٍ واحدة، أسمع النداءات قبل أن تصل، يصِلني ارتجاف الأجهزة قبل أن يرن، أحبُّ لحظات الهدوء، لكنها قليلة، وتشبه صمتًا على وشك الانفجار
صرخت الممرضة من داخل الاستقبال: “حالة صدر! افتحوا الطريق!” انشق الطابور، دخل الرجل كحفنة رملٍ تنهار. وجهه شاحب مشدود، عيناه تُبحران في سقفٍ ملطّخٍ ببقع الرطوبة، وفمه نصف مفتوح كأنه يبحث عن نفسٍ لم يعد يعرف طريقه، قالت زوجته بصوتٍ يختلط بالبكاء: “يا دكتور… صدره اتخنق من العصرية وتعب علينا في السلم…” وأشارت إلى صدره بيدٍ ترتعش
انحنى طبيب الامتياز فوقه، تلك الوجوه الشابة المتعبة التي لا تنام، وأخذ التاريخ بسرعة: ألم ضاغط في الصدر، يمتد للذراع اليسرى، تعرّق شديد، قيء. وضع جهاز رسم القلب، الدبابيس المعدنية الباردة على جلدٍ محموم، الورقة خرجت شرائط متكسّرة، نظرت إليه من بعيد، لم أكن أقرأ رسم القلب عادة، لكنّي رأيت خطوطًا كالسكين، رفع الطبيب الشاب رأسه، نظر إلى الممرضة:
“St-elevation واضح…
هاتِ الأسبرين، كلوبيدوجريل، هيبارين، نيترو… والأكسجين بسرعة، وضعتُ لهم على الكاونتر درجًا من الأمبولات وأقراصًا في ظرف، سحبت الممرضة الكراش كارت، خطواتي تسابق أصابعهم، كان الرجل يتلوى كما لو أن صدره يتحول إلى حجر. قال الطبيب الشاب وهو يثبت قناع الأكسجين: “يا جماعة، محتاجين سرير عناية فورًا، والكاث لاب… اتصلي بالعناية، استدعى الطبيب المناوب” رفعت الممرضة السماعة، انتظرت، ثم هزّت رأسها، وأغلقت: “مافيش أسرّة فاضية يا دكتور… العناية فول” عاد الطبيب وابتلع ريقه: “طيب كلّموا العناية التانية في المبنى الجديد”. نفس الأمر
كان مع الرجل ابناه في أول العشرينات، يقفان كتمثالين أمام العجز. قال الأكبر: “يعني إيه مفيش؟” لم يجبه أحد. أخرجت الزوجة بطاقة الرقم القومي وملفًا أخضر مهترئًا: “دفعنا اشتراك التأمين يا دكتور… كله تمام” كان الطبيب الشاب لا يزال يحاول، اتصل بالمشرف على النوبتجية، طبيب أكبر سنًا، يملأ الهواء بمجرد ظهوره، بالونة من خبرةٍ وثقة، جاء بعد دقائق وهو يرتدي البالطو الأبيض كمعطف سلطة، ألقى نظرة سريعة على الورقة، ثم نظر إلى الرجل، ثم إلى الساعة: الحق الآن قسطرة فورية… وإحنا ما عندناش كاث لاب شغال بالليل، لازم تحويل لمستشفى خاص
قالت الزوجة: “طب يا دكتور التأمين…” رفع الطبيب حاجبه، كأنها تذكّره بشيءٍ غير مناسب في الوقت الراهن: “التأمين… الإجراءات… والمريض مش مستحمل دلوقتي، المستشفى الفلاني عنده سرير عناية وقسطرة جاهزة، عربية الإسعاف الخاصة هتيجي حالًا تاخده، هو ده الحل الوحيد” كانت كلماته محبوكة بلا تلعثم، وكأنها نداء صلاة محفوظ
شعرت بتيارٍ بارد يمرّ في رأسي. أعرف هذا السيناريو: الباب نفسه، الجملة نفسها، المستشفى الخاص نفسه، والسيارة نفسها، نظرت للممرضة فابتعدت بعينيها. الطبيب الشاب تمتم: “لو فيه ضغط على العناية… ممكن نفتح سرير مؤقت…” قاطعه المشرف بعينين ضيقتين: “هتغامر بحياته؟ مين يوقع على المخاطرة؟ تقول أنت وانا أتحاسب؟” ثم التفت لأهل المريض: “الوقت من ذهب، أي تأخير خطر”
رأيت مرتبته تُسحب تدريجيًا من تحت حق المواطن، رأيت التفافية حريرية على رقبة الحقيقة، لم أتكلم، في هذه اللحظات، يتحول الصيدلي في الطوارئ إلى ظل، نُعطي الحقن ونملأ الفراغات، ونقرأ بين السطور
أتت مسؤولة الإدخال بسرعة، تحمل أوراق “تحويل بموافقة الأهل”، ورقة جاهزة وكأنها تنتظر اسمًا جديدًا لتبلله، قرأت الزوجة بصوت متحشرج بعض البنود: “… يقر الطرف الأول بالموافقة على التحويل… ويتحمل التبعات المادية… وتخلي المستشفى مسؤوليتها…” كان خطّ زوجها يرتطم بالبياض على استحياء، قال الابن الأصغر بحدة لم يستطع إخفاءها: “طب ما هو هنا مستشفى كبير! فين حقنا؟” رد المشرف وهو يرتدي ابتسامة المعلم: “حقكم إننا نتصرف بسرعة… وهنا مافيش إمكانيات بالليل، سيادة المواطن، ده أفضل علاج”
جاءت سيارة الإسعاف الخاصة على عجل، لونها الأبيض لامع بطريقة تذكّرني بأسنانٍ مبالغٍ في لمعانها بابتسامة هوليوود. الفنار الأزرق يومض كإعلان، حملوه بسرعة إلى الداخل، وركضت الزوجة خلفهم تتعثر في إيصالٍ لم تدفعه بعد، نسيت أن تحكم حجابها، كشفت ريحٌ طائشة عن خصلة شعرٍ أبيض، وقّع الابن الأكبر ورقة على بياض، يدٌ تكتب وعينٌ على وجه أبيه، لا يفهم شيئًا مما يفعل إلا أنه يدفع الباب بكل ما يملك ليدخل
التفتُّ إلى الطبيب الشاب بعد أن ابتعدت العجلة، كان يقف جوار الحائط كأنّه فقد ظله، قلت له بهمس: “مافيش فعلًا سرير؟” رفع كتفيه: “في الحقيقة… فيه سرير فاضي من بدري… بس عليه اسم حالة جاية بكرة من مكتب… تعرف” فهمت الاسم الذي يأتي من الأعلى قبل أن يكمل، يأخذ سريرًا حتى لو لم يصل صاحبه، قلتُ: “طب ليه ما حاولتش؟” قال وهو ينظر إلى البلاط: حاولت. بس الأستاذ… واللي فوق الأستاذ” لم يكمل
رجعت إلى شباكي، رتبت الأمبولات ببطء، أصابعي تتحسس برودة الزجاج، دخل عامل النظافة وبيده ممسحة قديمة، لمَح بقعة دم منخفضة على البلاط، مسحها بسرعة، ترك مسحة وردية كجرحٍ خجلان، قلت لنفسي: “الدم لا يختفي، يغيّر لونه فقط”
بعد نصف ساعة، رنّ هاتفي الخاص برقمٍ غريب. كان الابن الأكبر. لا أعرف من أين حصل على رقمي؛ ربما من ورقة مرفقة باسمي في أوراق الدواء. قال بصوتٍ يختنق: “يا أستاذ يونس… طالبين إيداع مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه عشان يدخل العناية… وأنا… أنا ماعنديش.” سألته: “ووالدك الآن؟” قال: “بيعملوا له حاجات… بس قالوا مش هيدخل العناية إلا لما ندفع.” سكتُّ لحظة. أحسست أن الكلام سكين ذو حدين. قلت له: “ممكن تحاول مع مكتب خدمة المواطنين هنا… بس مافيش إجراءات دلوقتي بالليل… ولو رجعتوا هنا…” لم أكمل. نحن دائرة تبتلع أطرافها
عُلّقت المكالمة، وبقي الصوت في أذني. نادى عليّ المشرف: “يا يونس… جهّز أوراق بعض أدوية الطوارئ للحالة اللي جاية من بره. حيبعتوا روشتة من المستشفى الخاص” ابتسم ابتسامة قصيرة، ضيّقة، كأنها استراحة بين صفقتين. دخلت على حسابي القديم في الذاكرة؛ تذكرت أن المستشفى الخاص هذا يرسل لنا بعض الأدوية على نفقة الدولة لاحقًا بإجراءاتٍ تبتلع شهورًا، ونحن نرسل لهم اللحظة نفسها روحًا طازجة مقابل شيكٍ عاجل، الادوية تنتظر شهورا بين الأوراق، أما الأرواح فتضيع في لحظتها، والشيكات تصرف فورا، همست لى نفسي مندهشة: المال تطارده الشيكات مسرعة، والدواء يبتلعه الروتين البطئ، وحدها الأرواح تهوى طازجة، كأنها الثمن العاجل
مرّت ساعة أخرى. وصلتني رسالة واتساب من ممرض أعرفه هناك. لا أدري لماذا أرسلها لي، ربما يظنني شريك سرّه، أو ربما أراد اعترافًا. كانت صورة شاشة لمحادثةٍ جماعية، فيها اسم المشرف عندنا، ورسالة قصيرة: “وصلت الحالة. شكراً يا دكتور. النسبة كالعادة.” شعرت بارتجافةٍ في أصابعي. وضعت الهاتف على الطاولة، مددت يدي إلى كوب الشاي الذي صار باردًا كقلب ورقي
خرجت إلى الممر، الهواء أشد برودة. في زاوية الممر، رأيت الممرضة الكبيرة التي تعمل منذ ثلاثين سنة لمعت عيناها قالت بلهجة أم: “على فكرة… لو عايز يتصرّفوا في السرير… فيه ناس بتعرف تتكلم… كل حاجة ليها حل”, لا أريد أن أعرف “الذين يعرفون الكلام”, في جيبي صورة شاشة تشبه الرشوة وهي ترتدي ثياب الشك
في الرابعة صباحًا، عاد الابن الأكبر إلى المستشفى وحده. عيناه حمرتان، وثوبه مبتل، لا أدري إن كان المطر أم العرق أم شيء آخر. وقف أمام شباكي، قال: “أبويا… عملوا له قسطرة… وقالوا اتأخرنا ساعة… وقالوا محتاج دعامة… وقالوا لازم فلوس… و… أنا مضيت شيكات.” جلس على الكرسي المجاور دون إذن، وضع رأسه بين يديه. وضعت أمامه كوب ماء بلاستيكي. قال وهو لا يزال ينظر إلى الأرض: “أبويا كان عامل في شركة الغزل… خرج معاش من سنتين… ما عندناش حاجة تتباع غير الدهب اللي في إيد أمي… هبيع… أي حاجة.” رفعت عيني إليه، أردت أن أقول شيئًا يخفف حمله، لكن وجدت داخلي كلماتٍ تافهة، فابتلعتها مع ريقي
عاد المشرف يمرُّ في الممر كعاصفة هادئة. قال وهو يميل نحوي: “على فكرة يا يونس… ماينفعش تدخل نفسك في حاجة بره شغلك. أنت صيدلي… شغلك الدوا. الكلام في التحويلات مش ليك.” ابتسم ابتسامةً تحذيرية، ثم ابتعد. ترك خلفه رائحة عطر ثقيل تختلط برائحة المطهر الرخيص، فتنتج شيئًا يصيبني بالصداع والغثيان في نفس الوقت
مع شروق الشمس، بدأ ضوء باهت يزحف إلى الردهة، يفضح الغبار المتراكم في الزوايا. جاء خبرٌ من المستشفى الخاص عبر الممرض نفسه، بكلمات مختصرة: “المريض دخل العناية. الحالة غير مستقرة.” ثم بعد ساعتين: “وقف القلب خمس دقايق، رجعوه…”. في الظهيرة: “الضغط بينزل… محتاجين أدوية باهظة…”. في المساء: “ادعو”
في اليوم الثالث، دخل الابن الأصغر مرة أخرى، ولكن مع رجلين يلبسان جلابيب داكنة، يحملان وجوهًا جافة كالقش. كان يحمل ورقة طويلة كالليل، قائمة حساب، تتدلى منها أرقام تصعد كالسلالم إلى سقف لا يُرى، قال: “يقولوا لازم نكمل باقي الحساب وإلا مش هيطلعونا تصريح الدفن لو حصل حاجة.” نطق الكلمة الأخيرة بخفوتٍ يجرح الأذن، حدّق في الورقة، كأنه يقرأ وصيةً لا تخصه، ثم قال: لماذا تحولونا لمستشفى غير متعاقدة مع التأمين؟ قلت له: “فيه مكتب شكاوى… وفيه محامي في النقابة… وفيه…” كنت أعرف أن كل هذا سيأخذ أسابيع، وأن الزمن الوحيد الذي يعمل بسرعة هو زمن الفاتورة
في مساء اليوم الرابع، جاء الخبر الأخير. مات الرجل. اختلفوا على التوقيت الدقيق، لكني لا أهتم. في بلادنا، يموت الناس في أكثر من وقتٍ واحد: يموتون في الإسعاف الأولى، ثم يموتون في الورقة التي تقول “تحويل بموافقة الأهل”، ثم يموتون مرةً أخيرة حين يغلق الموظف ملفهم ويضعه في درجٍ لا يُفتح كانت الزوجة تُخرج من شنطتها رائحة القرنفل وزغاريد قديمة ماتت من زمان، وتبكي كما تبكي الريح حين تصطدم بشباكٍ معدني صدئ
بعد الدفن، عاد الابنان إلى المستشفى الخاص للمحاسبة، جلسا أمام موظفٍ أنيقٍ يلبس نظارة رفيعة الإطار، يبتسم كأنه يقدم عرضًا على شاشة مسطحة. قال لهما: “إحنا متعاطفين جدًا… بس ده النظام القسطرة، العناية، الأجهزة، الأدوية، المستلزمات… كله محسوب. وعلشان إحنا ناس بنراعي الظروف… ممكن نقسّط جزء.” كانت “المراعاة” وردة بلا رائحة على قبرٍ جديد
في الأسبوع التالي، وصل إلى مكتب المدير خطاب شكرٍ من المستشفى الخاص، يشيد بـ”سرعة التعاون المثمر بين المؤسستين” عُلّقت نسخة منه على لوحة الإعلانات في الردهة. مررتُ بجوارها، قرأت سطرين، شعرت أن الحروف تتحول إلى حبالٍ تتدلّى من السقف. في نفس اليوم، استدعاني المدير. غرفته مكيفة الهواء، فوق مكتبه مصحف مفتوح على صفحةٍ لا تُقرأ، وتحت المصحف ملفّاتٌ عليها ترابٌ ناعم. قال لي وهو يبتسم ابتسامة أبوية: “يا يونس… سمعت إنك متضايق من إجراءات التحويل. أحب أفكرك إن النُظُم موضوعة لحماية الجميع. وبلاش كلام في فيما لا يخصك. على فكرة… فيه لجنة جاية من الهيئة… مش عايزين حد يجيب سيرة حاجة تشوّه سمعتنا. فهمت؟” قلت وأنا أنظر إلى صورة على الحائط لوزيرٍ سابق لم يعد في منصبه: “فهمت”
في الليل، حين هدأ الممر، جلست على الكرسي المعدني خلف الشباك، وضعت البالطو الأبيض على ركبتي. لمحت بقعةً صغيرةً وردية عند الكم، كأنها زهرة خجولة. تذكرت الرجل حين جذبني من ساعدي وهو يُنقل إلى الاسعاف الخاص، أظافره حفرت في قماشي، ربما ترك أثرًا من عرقه أو دمٍ صغير خرج من موضع الكانيولا، حاولت أن أفركها بمطهّر، اتّسعت قليلًا ثم خفتت، لكنها لم تختف، قلت في نفسي: “هسيبها” لا لأني أحب العلامات، بل لأن النسيان في هذا المكان أخطر من التذكر
مرت أيام، ثم أسابيع. الحالات تتشابه وتختلف، الأسماء تتبدّل، والورق نفس الورق. في ليلةٍ أخرى، جاءت حالة مشابهة نفس الوجع، نفس الجمل المحفوظة، نفس “لا يوجد سرير”. كنت واقفًا، أسند ظهري إلى الحائط، حين دخل الطبيب الشاب نفسه، عيناه محمرتان، لكن صوته صار أقسى، التفت إليّ كأنه يطلب شهادة، قال: “يا يونس… نعمل إيه؟” قلت له: “جرب العناية مرة تانية” أجابني بحسرة: “اتّصلت… قالوا سرير واحد… بس عليه اسم.” قلت: “اسم مين؟” قال: “الدنيا كلها” ابتسمنا ابتسامة قصيرة، لا تليق بالموت، لكنها الشيء الوحيد المتاح
هذه المرة، دخلت امرأةٌ بدينةٌ تضع إيشاربًا مزركشًا وتقف باستقامةٍ مختالة. تعرّفها فورًا إن كنت تعرف شجرة هذا المكان قالت وهي تُخرج هاتفًا حديثًا: “حدّثت الدكتور المسئول… السرعة مطلوبة. العربية الخصوصي جاهزة” نظرت إلى ساعتي، فكرت أن الزمن هنا ليس زمنًا مطلقًا، بل يُدار من جيبٍ إلى جيب، نحّيت وجهي قليلاً كي لا أرى عقدها الذهبي يتراقص عند كلمة “جاهزة”
في الليل، بعد أن غادرت الحالة الثانية أيضًا إلى نفس المستشفى، قررت أن أكتب، لا بلاغات كِبَار ولا رسائل رسمية، فقط ورقة بيضاء وقلم أسود. كتبت كل شيء كما حدث، بلا أسماء حقيقية، بلا اتهامات صريحة، فقط تفاصيل دقيقة: وقت الدخول، القراءات، الاتصالات، الردود، كلماتنا الصغيرة التي تتكرر وضعت الورقة في ظرف بني، كتبت على ظهره “لمن يهمه الأمر”. تركته في درجٍ لا يفتح إلا إذا قرر صاحبه أن يرى، أعلم أن الظرف قد لا يُقرأ، أن الورقة ستصير طبقة إضافية في جيولوجيا الغبار على مكتبٍ لا يغلق، لكني كتبت، الكتابة هنا ليست شجاعة، بل نوع من مقاومة الانقراض
في ظهيرة السبت، خرجت من المستشفى أجرّ قدميّ فوق رصيفٍ متكسر. كان السوق قد بدأ بسط بضاعته: خضار مفروش على الأرض، شباب يقفون أمام مقهى صغير، صوت أذان الظهر يتسلل من مسجد قريب. عبرتُ الشارع، كادت سيارة أن تصدمني، توقف السائق وأخرج رأسه: “خلي بالك يا دكتور!” رفعت يدي اعتذارًا. في زجاج السيارة الجانبي رأيت انعكاسي للحظة: وجه شاحب وبالطو أبيض كتفه يميل إلى أسفل. تذكرت البقعة الوردية على الكمّ، رفعت يدي قليلًا، نظرت إليها كانت لا تزال هناك، لا تكبر ولا تصغر، وكأنها اكتسبت حقّ الإقامة
عدت إلى البيت، وجدت أمي قد تركت على الطاولة رغيفين ساخنين وكوب شاي بالنعناع. جلست على الكرسي الخشبي القديم. قالت أمي وهي تقلب القنوات: “عاملين إيه في المستشفى؟” قلت: “بنعدّي اليوم بيومه.” قالت: “المهم ربنا يرضى” ابتسمتُ لأنّنا، حين نُهزم، نبحث بسرعة عن جملةٍ تُسكّن الروح. أغلقت عيني لدقيقة. سمعت في رأسي جملة المشرف: “النسبة كالعادة.” فتحت عيني بسرعة كمن يقطع كابوسًا. قلت في سري: “لو كان للموت صوتٌ في الورق، لصرخ”
في اليوم التالي، وأنا أجهّز رف الطوارئ، دخل شاب نحيل يحمل ملفًا أخضر عليه اسم أبيه، كان من القرية نفسها التي جاء منها الرجل الأول، قال وهو يتلعثم: “أنا… كنت مع عمي في الحالة اللي فاتت… اللي اتنقلت… أبويا النهاردة تعبان برضه… بس احنا مش هنطلع خاص…ولو طلعنا، حنطلع على مستشفى فيها تعاقد تأمين، اتوسّطنا، قالوا في سرير عناية هنا النهارده، أنا جيت بدري أحجزه” نظر إليّ برجاء يشبه الرجاء الذي سبقه، ويتلوه رجاءٌ آخر. قلت له: “ربنا يسهل” اتصل الطبيب الشاب بالعناية مرة أخرى، أجابوا: “أيوه… فيه سرير فاضي.” نظر الطبيب إليّ بسرعة، بعينين فيهما لمعة صغيرة كبرقٍ بعيد، بعد ساعة، دخل الأب العناية. كنت في الممر حين مرّ المشرف، توقف أمامي وقال: “شايف؟ كل حاجة بتتظبط” ثم مضى. لم يترك عطرًا هذه المرة، ترك فكرة معلّقة في الهواء: من الذي قرر أن يكون اليوم ترتيبًا مختلفًا؟ من الذي أعطى وعد “السرير” لهذا وأخذه من ذاك؟ لا أحد يجيب، لأن الإجابة ليست كلمة بل شبكة
في مساء اليوم نفسه، قبل أن تنتهي نوبتي بقليل، جاءني ظرفٌ صغيرٌ بلا اسم. فتحته، وجدت فيه ورقة مطبوعة بخط مهني. كانت “استبيان رضاء متلقي الخدمة” من المستشفى الخاص، تحمل أسئلة عن “مدى الرضا عن جودة التحويل”، وبالأسفل شعارٌ أنيق وكلمات بالإنجليزية عن “الشراكة”. وضعت الورقة على الطاولة، ضحكت ضحكة قصيرة من ذلك النوع الذي يشبه السعال. كتبت بقلم رصاص كلمة واحدة على الاستبانة قبل أن أعيدها في الظرف: “دم”
خرجت إلى السلم الخلفي حيث يقف بعض العمّال يدخنون. رميت الظرف في سلةٍ معدنية، اشتعلت فيه شعلة صغيرة ثم انطفأت بسرعة. نظرت إلى كمي مرة أخرى، البقعة الوردية لا تزال هناك. مددت أصابعي أتحسسها. كانت خشنة قليلًا، كأنّ القماش تذكّر أنه لمس حياةً انطفأت إليه لحظة. قلتُ وأنا أنزل الدرج: لن أعدّ هذا طَبعة عار. سأعدّه تذكيرًا بأن البالطو الأبيض ليس ضمانًا… بل سؤالًا دائمًا
في الليل، كتبت في دفتري جملة واحدة، تركتها في أول صفحة كي تراها عيني كلما فتحت الدفتر: “ما بين سريرٍ لا يفتح، وبابٍ يُفتح على سيارة خاصة، يضيع في بلادنا رجلٌ كل ليلة؛ والشيء الوحيد الذي يبقى على قماشنا هو أثر الدم” ثم أغلقت الدفتر وصفّرت، نعم صفرت، الصفير هنا ليس بهجة، إنما هو شيء يشبه قاربًا صغيرًا يبحر في قاعة انتظارٍ لا تنام
وفي اليوم الذي تلاه، حين سألني الطبيب الشاب: “يا يونس… هنفضل كده؟” قلت: “لا أعرف” ثم أضفتُ بعد صمت: “لكن كل مرة تتلوّن البقعة… لازم حدّ يشوفها وما يطنّش.” هزّ رأسه وقال: “يمكن.” ثم اتجه إلى المريض التالي الذي دخل محمولًا على بطانيةٍ رمادية. أزحتُ الخط في رفّ الأمبولات خطوةً إلى اليمين، جهّزت الأسبرين والهيبارين، وسرتُ وراءهم. في الممر الطويل، كانت أجهزة الأكسجين تلمع كعود ثقابٍ قصير، وكان الوقت، كعادته، يركض بثيابٍ من كذبٍ مهذّب
عند نهاية الممر، قبل باب الطوارئ، رفعت يدي وعدّلت كمّ البالطو بحيث تظهر البقعة بوضوح. لم يكن ذلك فخرًا، ولا تحدّيًا، إنما اعترافٌ بسيطٌ بأننا، نحن الذين نكتب الأدوية ونحمل البطانيات ونزيح عربات الإسعاف، لسنا خارج الحكاية. نحن داخلها حتى آخر نقطةٍ ورديةٍ على القماش، وفي بلادٍ يتكاثر فيها الورق وتصغر فيها الأسرة، قد يكون الاعتراف أول خطوةٍ صغيرة، لا تُرى من بعيد، لكنها تُسمع حين يهدأ الصرير المبحوح لبابٍ زجاجي يفتح ويغلق طوال الليل