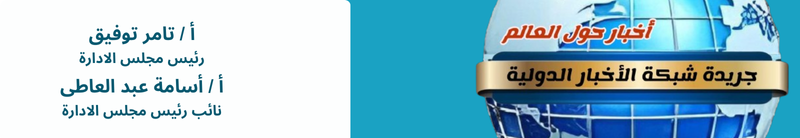كتب : هاني رفعت
في السنوات الأخيرة، برزت ظاهرة يمكن وصفها دون مبالغة بأنها مرض اجتماعي معاصر؛ مرض لا يرتبط بسن أو مهنة أو مستوى ثقافي، بل يجمع أصحابه على سلوك واحد: الهوس بالظهور والقرب من المشهد، أيًّا كان هذا المشهد ومهما كانت قيمته.
نلتقي بأشخاص لا يعنيهم مضمون الحدث بقدر ما يعنيهم موقعهم منه. لا يهم إن كان الدور صامتًا، أو الوجود هامشيًا، أو المشاركة بلا أثر حقيقي؛ المهم أن يكونوا في الكادر، قريبين من الكاميرات، تحت الأضواء، أمام عدسات المصورين. وكأن الوقوف قرب المشهد أصبح غاية في حد ذاته، لا وسيلة ولا نتيجة.
هذا السلوك لم يعد مجرد حب للظهور، بل تطور إلى ما يشبه إدمان الضوء. الكشافات هنا تلعب دور المحفز، والعدسة تصبح اعترافًا رمزيًا بالوجود، حتى لو كان هذا الوجود بلا قيمة أو تأثير. فالبعض بات يخلط بين “الحضور” و“الإنجاز”، وبين “الصورة” و“الدور الحقيقي”.
المشكلة الأعمق أن هذا المرض يفرغ المشاهد من معناها. حين يزاحم الهواة أصحاب القضية، وحين يتقدم الباحثون عن اللقطة على صناع الحدث، تتحول القضايا إلى خلفيات تصوير، وتضيع الرسائل وسط سباق الظهور. فيصبح المشهد مزدحمًا بالوجوه، فقيرًا في الفعل.
اللافت أن أصحاب هذا الهوس غالبًا ما يعتقدون أن قربهم من الحدث يمنحهم قيمة تلقائية، بينما الحقيقة أن القيمة لا تُستمد من الموقع، بل من التأثير. فليس كل من وقف تحت الضوء نجمًا، وليس كل من ظهر في الصورة صانعًا للمشهد.
إن أخطر ما في هذا المرض أنه يتغذى على التصفيق السريع والاهتمام اللحظي، ويصنع وهمًا بالنجومية، بينما يترك فراغًا حقيقيًا على مستوى الفعل والمسؤولية. مجتمع يعاني من هذه الظاهرة هو مجتمع يخلط بين المظاهر والجوهر، ويكافئ الظهور أكثر مما يكافئ العمل
وفي الختام، يبقى السؤال مطروحًا:
هل نحتاج مزيدًا من الوجوه أمام الكاميرا؟
أم نحتاج أفعالًا حقيقية حتى لو تمت بعيدًا عن الكادر؟
فالتاريخ لا يتذكر من كان أقرب للمشهد،
بل من صنع المشهد.