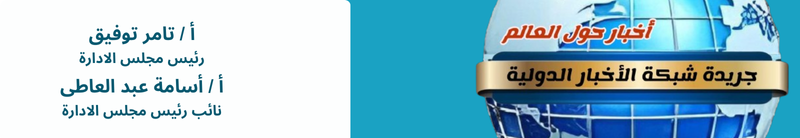بقلم: منال الشربيني
هل الفشل قدر لا مفر منه أم أنه مجرد محطة عابرة على طريق أطول نحو النجاح؟ هذا السؤال لم يعد ترفًا فلسفيًا أو نقاشًا أكاديميًا محضًا، بل صار جزءًا من انشغالاتنا اليومية في زمن تتراكم فيه الأزمات الاقتصادية و تشتد فيه المنافسة السياسية تزداد فيه الضغوط التعليمية والنفسية إلى حدود لم يعرفها الإنسان من قبل. الفلاسفة، منذ ألبير كامو حتى جان بول سارتر، رأوا أن الفشل ليس مجرد حدث خارجي، بل حالة وعي بالقصور، انعكاس عبثية الوجود ومحاولة لمقاومة المعنى المفقود (Camus, 1942؛ Sartre, 1943). أما علم النفس فيقدمه كنتيجة لسلوك أو خطة غير فعالة، محمّلة بالقلق والإحباط وتراجع تقدير الذات (Seligman, 1975).
بينما ينظر علم الاجتماع إليه بوصفه ظاهرة جماعية تتجلى في معايير النجاح المهيمنة داخل المجتمع، سواء كانت المكانة أو الثروة أو الاعتراف الاجتماعي (Merton, 1968).
لكن الفشل ليس قالبًا جامدًا، بل يتعدد بحسب الزاوية التي نراه منها. فحين يركّز الفرد على ذاته قد يُعزي فشله إلى ضعف الانضباط الذاتي أو قلة المهارات أو التشاؤم الذي يعيق التجربة. وتوضح أبحاث كارول دويك أن الطلاب الذين يتبنون “عقلية ثابتة” غالبًا ما يفسرون الإخفاق كدليل على قصور جوهري لا يمكن إصلاحه (Dweck, 2006). أما عندما نوسع الدائرة إلى المجتمع، فإن الفشل يصبح انعكاسًا لبنى اقتصادية غير عادلة تجعل الفقراء أكثر عرضة للإقصاء التعليمي والمهني بسبب نقص الدعم المؤسسي لا لقصور ذاتي (Bourdieu, 1986). وفي منظور تاريخي–ثقافي، قد يُقرأ الفشل في سقوط حضارات بأكملها مثل روما، حيث عُزي الانهيار إلى الفساد الأخلاقي أو ضعف البنى الاقتصادية والعسكرية (Toynbee, 1934).
تتوزع أسباب، بدورها، بين داخلية وخارجية. داخليًا، يمكن أن يكون الفشل نتاجًا الخوف يشلّ القدرة على المحاولة، وهو ما يسميه ألبرت إيلليس “شلل التحليل” (Ellis, 1962)، أو نتيجة اعتقادات سلبية تخلق نبوءات تحقق ذاتها (Merton, 1948). وفي لغة سارتر، هو غياب المشروع الأصيل الذي يمنح للحياة معناها (Sartre, 1943). خارجيًا، تفرض البيئة الاجتماعية عدم تكافؤ الفرص الذي يجعل النجاح امتيازًا لا حقًا، كما أوضح أمارتيا سن (Sen, 1999). وتضاعف النظم الاقتصادية هذا الواقع حين تختزل قيمة الإنسان في قدرته على تحقيق إنجاز مادي فحسب (Bauman, 2000). أما ثقافة العيب في مجتمعات كثيرة فتجعل الفشل ليس مجرد تجربة شخصية بل وصمة تلاحق الفرد وعائلته.
على مستوى المقارنات الثقافية، يتجلى التباين بوضوح. ففي الغرب، خصوصًا في وادي السيليكون، يُحتفى بالفشل كخبرة تعلم، بل ويُعتبر جزءًا من رأس المال الرمزي لرائد الأعمال (Edmondson, 2011). بينما في المجتمعات الشرقية، يظل الفشل أقرب إلى الوصمة الاجتماعية التي تُقلّص فرص إعادة المحاولة (Hofstede, 1984). حتى على المستوى الفكري، تتباين القراءات: الفلاسفة الوجوديون يرونه قدرًا وجوديًا وفرصة لإعادة خلق المعنى (Camus, 1942؛ Sartre, 1943)، فيما ينظر علم النفس الإيجابي إليه كبداية جديدة لتدريب الذات على ما يسميه مارتن سليجمان “التفاؤل المتعلم” (Seligman, 1975).
النظريات التي تناولت الفشل أضافت عمقًا لهذا الفهم المتشابك. فقد قدّم سليجمان مفهوم “العجز المتعلم” ليشرح كيف أن الفشل المتكرر يقود الفرد إلى الاستسلام (Seligman, 1975). وذهب فيغفيلد إلى أن الفشل يحدث عندما يقل تقدير الفرد لقيمة الهدف أو يقل توقعه لنجاحه (Wigfield, 2000). أما ميرتون فقد ربط الفشل الجماعي بتناقض خطير بين الأهداف التي يروجها المجتمع والوسائل المتاحة لتحقيقها (Merton, 1968). في حين أكد كامو أن الفشل ليس مسألة نجاح أو إخفاق عملي بقدر ما هو انعكاس لعبثية الحياة نفسها، والرد الأمثل ليس في النجاح بل في التمرد (Camus, 1942).
ما يخرج به القارئ من هذا كله هو أن الفشل ليس كيانًا واحدًا يمكن تفسيره من زاوية واحدة. إنه نتاج تفاعل معقد بين الفردي والاجتماعي والثقافي، بين الداخل النفسي والخارج البنيوي. الفرد قد يسقط ضحية مخاوفه وقناعاته، كما قد يقع أسيرًا لقيود المجتمع والاقتصاد. والمجتمع بدوره قد يصنع فشلًا بنيويًا عبر مؤسساته، أو يخفف من قسوته عبر الدعم والاحتواء. ومن ثم، فإن الفشل لا ينبغي أن يُفهم وصمة ولا عيب، بل كمرآة تكشف حدود الإنسان والمجتمع، كأداة يمكن أن تتحول من لعنة إلى طاقة للتغيير.
التحدي الحقيقي اليوم ليس في محو الفشل من حياتنا، فهذا مستحيل، بل في إعادة تعريفه وإعادة توظيفه. أن يصبح جزءًا من ثقافتنا التعليمية والإعلامية باعتباره تجربة تعلم، وأن تعاد صياغة السياسات الاجتماعية بما يضمن تكافؤ الفرص، وأن يتدرب الأفراد على تقبل الإخفاق لا باعتباره سقوطًا بل خطوة في مسار أطول. وحين نصل إلى هذه المرحلة، يمكن أن نحتفل بالفشل لا كعلامة ضعف، بل كبداية لقوة جديدة. فالفشل، في جوهره، ليس النهاية التي نخشاها، بل الانطلاقة التي نحتاج إليها كي نعيد اختراع أنفسنا في عالم لا يكف عن التغير.
…
المراجع
Bauman, Z. (2000). Liquid Modernity. Polity Press.
Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), Handbook of theory and research for the sociology of education (pp. 241–258). Greenwood.
Camus, A. (1942). Le Mythe de Sisyphe. Paris: Gallimard.
Dweck, C. (2006). Mindset: The new psychology of success. Random House.
Edmondson, A. (2011). Strategies for learning from failure. Harvard Business Review, 89(4), 48–55.
Ellis, A. (1962). Reason and emotion in psychotherapy. Lyle Stuart.
Hofstede, G. (1984). Culture’s consequences: International differences in work-related values. Sage.
Merton, R. K. (1948). The self-fulfilling prophecy. The Antioch Review, 8(2), 193–210.
Merton, R. K. (1968). Social theory and social structure. Free Press.
Sartre, J.-P. (1943). L’Être et le Néant. Paris: Gallimard.
Seligman, M. E. P. (1975). Helplessness: On depression, development, and death. Freeman.
Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.
Toynbee, A. (1934). A study of history. Oxford University Press.
Wigfield, A. (2000). Expectancy- value theory of achievement motivation. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 68–81.