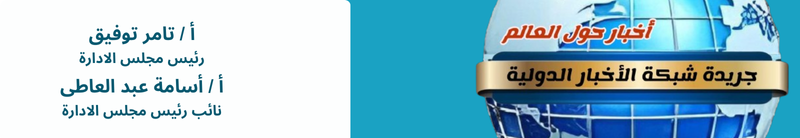الكاتب الصحفي والناقد الفني عمر ماهر
في الصباحات التي تتكئ على ضوءٍ خفيفٍ يشبه الأمل، وتتناثر فيها خطوات الطلاب كأوراقٍ تبحث عن شجرة المعرفة، يولد اسمٌ مختلف، اسم لا يُنادى كلقبٍ أكاديمي بارد، بل كحكاية دفءٍ كاملة. هناك، بين الجدران العتيقة والدفاتر المرهقة والمواد الثقيلة، كانت الحكاية تبدأ دائمًا بصوتٍ هادئٍ يشبه الطمأنينة، كأن القانون قرر أن يخلع صرامته ليرتدي إنسانيته. لم تكن مجرد أستاذة تمرّ عابرة في جدول المحاضرات، بل كانت أثرًا، ونورًا، ونقطة تحوّل في حياة كل من جلس يومًا في مقعدٍ ينتظرها. كانت الدكتورة ميادة.
داخل حرم ، وتحديدًا في أروقة ، لم يكن الطلاب ينتظرون محاضرة القانون المدني كأي مادة أخرى؛ كان هناك شعور مختلف يسبق اللحظة، خليط من الاحترام والمودة والترقّب الجميل. وما إن تظهر في الممر حتى يتبدل المشهد كله؛ الوجوه المتوترة تهدأ، والهمسات تتحول إلى ابتسامات، وكأن المكان نفسه يعرف أن إنسانة استثنائية على وشك أن تعبره. لم تكن تدخل بسلطة المنصب أو رهبة اللقب، بل تدخل ببساطة تشبه البيوت القديمة الدافئة، بابتسامة صادقة ونظرة مباشرة تقول للطلاب دون كلمات: “أنا هنا لأجلكم”.
لم تكن من أولئك الذين يختبئون خلف السبورة أو يغرقون القاعة بالمصطلحات المعقدة. لم تكن تحتاج إلى سبورة أصلًا. كانت تؤمن أن العقول تُفتح بالكلمة الحية لا بالطباشير، وأن أفضل شرح هو الذي يلامس القلب قبل الأذن. لذلك كانت تجلس أو تقف بينهم، تنظر في أعينهم، وتبدأ الحكاية. نعم، كانت تحكي القانون كما لو كان قصة حياة، لا مادة دراسية. عقد البيع يصبح مشهدًا من سوق شعبي، والتعويض يتحول إلى صرخة مظلوم، والمسؤولية المدنية تصبح موقفًا إنسانيًا يعيشه الجميع. فجأة يكتشف الطالب أنه لا يدرس نصوصًا صماء، بل يفهم الحياة من خلال القانون، ويفهم القانون من خلال حياته.
كانت كلماتها تنساب بسلاسة، جمل طويلة عميقة لكنها قريبة، تضرب الأمثلة وتنسج المواقف وتفتح أبواب النقاش، فلا يبقى أحد مجرد مستمع سلبي. الكل يشارك، الكل يفكر، الكل يشعر أن له صوتًا. وهنا يكمن سرها الحقيقي؛ لم تكن تملأ دفاترهم بالملاحظات، بل تملأ عقولهم بالوعي وثقتهم بأنفسهم.
وربما كان سر المحبة الجارفة لها أنها لم تتعامل يومًا مع الطلاب كأرقام أو أسماء في كشف الحضور. كانت تحفظ وجوههم، تتذكر ظروفهم، وتسأل عن الغائب قبل الحاضر. إذا تعثر أحدهم، كانت أول من يمد يده. وإذا نجح، كانت أول من يصفق بفخر. لم تكن علاقتها بهم علاقة أستاذ بطالب، بل علاقة أمٍ روحية بأبنائها. تجلس معهم بعد المحاضرات، تناقش أفكارهم، تراجع مشاريعهم، تقترح، تصحح، تشجع، وتمنح من وقتها بلا حساب، كأن اليوم لا ينتهي ما دام هناك طالب يحتاجها.
في زمنٍ صار فيه الوقت عملة نادرة، كانت هي تبذله بسخاء. وهذا السخاء الإنساني هو ما صنع مكانتها الحقيقية. فالعلم قد يصنع أستاذًا ناجحًا، لكن القلب وحده هو ما يصنع أستاذًا محبوبًا.
وبين كل هذا العطاء، لم تهمل يومًا جانبها الأكاديمي والبحثي. كانت تعمل في صمت يشبه الكبار؛ تقرأ وتبحث وتكتب، وتقدّم مؤلفات قانونية أصبحت مراجع مهمة لطلاب القانون المدني، كتب لا تتعالى على القارئ بل تقترب منه، تفكك التعقيد وتعيد صياغته بلغة واضحة وعميقة في آنٍ واحد. كانت تكتب كما تشرح، وكأنها تحاور القارئ لا تلقنه، وتضع بين يديه خلاصة خبرة وسنوات من الفهم والتجربة. لذلك لم تكن مؤلفاتها مجرد كتب دراسية، بل جسورًا حقيقية بين الطالب والمعرفة.
مع مرور السنوات، صار اسمها يتردد في الكلية بطريقة مختلفة. دفعات كاملة تتخرج وهي تحمل لها امتنانًا صادقًا، تحكي عنها كما تُحكى القصص الجميلة. طالب اختار تخصصه بسببها، وآخر استعاد ثقته بنفسه بفضل كلمة منها، وثالث وجد طريقه المهني بتشجيعها. هذه الأشياء لا تُكتب في السجلات الرسمية، لكنها تُكتب في القلوب إلى الأبد. وهذا هو النوع الوحيد من النجاح الذي لا يبهت مع الوقت.
كانت نموذجًا نسائيًا قويًا ومُلهمًا في عالم القانون، تثبت كل يوم أن المرأة قادرة على الجمع بين الحزم والحنان، بين الفكر العميق والقلب الكبير، بين القيادة والتواضع. لم تسعَ يومًا إلى الأضواء، لكن الضوء كان يتبعها أينما ذهبت.
وفي نهاية كل يوم، حين تغادر القاعة بهدوئها المعتاد، يبقى خلفها شيء يشبه الدعاء الصامت من طلابها، شيء لا يُرى لكنه محسوس؛ امتنان خالص لإنسانة جعلت من القانون رسالة رحمة قبل أن يكون مواد جامدة. وهكذا، لم تكن الدكتورة ميادة تكتب على سبورة، ولم تكن تحتاج إلى ضجيج أو استعراض، بل كانت تكتب اسمها في مكانٍ أعمق وأبقى في قلوب طلابها، حيث لا يمحو الزمن أثر الطيبين، ولا تنطفئ سيرة من جعلوا العلم حبًا، وجعلوا المعرفة إنسانية.