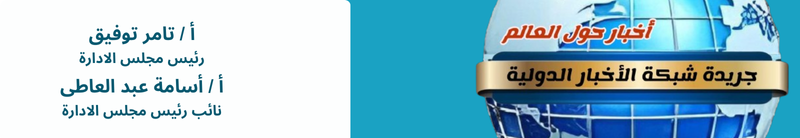سلسلة مقالات بقلم الأديب المفكر: د كامل عبد القوى النحاس
كمالُ البيان (4): إزالةُ توهُّمِ تضاربِ آياتِ القرآن
المُطْلَقُ والمُقَيَّد.. إشراقةُ القاعدةِ وإحكامُ القيد
تمهيد: في مِحرابِ البيان
من أسرارِ عظمةِ القرآن الكريم أنهُ كتابٌ يُخاطبُ العقولَ بالتدريج، ويأخذُ بالأرواحِ نحو الاستقامةِ بالترغيبِ والتوضيح.
فمن نَهجِهِ الحكيم أنه قد يرسلُ الحكمَ في موضعٍ إرسالاً عاماً (مُطلقاً)، ليرسخَ في النفسِ هيبةَ الأمرِ وعمومَ الفائدة،
ثم لا يلبثُ في موضعٍ آخر أن يضعَ لهذا الحكمِ سياجاً من الشروطِ (القيودِ)، لِيُعلِّمنا أنَّ العبادةَ ليست مجردَ فعلٍ، بل هي دقةٌ وإحسان.
فالمُطلقُ والمُقيدُ ليسا خصمينِ يتصارعان، بل هما “أصلٌ وفرع”، أو “لوحةٌ وإطار”؛ الإطارُ لا يحجبُ جمالَ اللوحةِ بل يحددُ مداها ويحميها من الشتات.
تأملاتٌ في الدليلِ والبرهان
المثال الأول: عِتْقُ الرقابِ (موازينُ الذنوبِ ومراتبُ الكفارة)
شرعَ اللهُ تحريرَ الإنسانِ من الرقِّ كفارةً للخطايا، ولكن انظر بقلبِكَ كيف غايرَ القرآنُ في “الصفة” ليعلّمنا فقهَ المقادير:
- في جنايةِ القتلِ الخطأ: قال سبحانه:
{وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92].
هنا جاء القيدُ ثقيلاً بكلمة “مؤمنة”، لأن الجرمَ هو إزهاقُ نفسٍ آمنت بربها، فكان من تمامِ العدلِ والقسطِ أن يكونَ التعويضُ إحياءَ نفسٍ مؤمنةٍ أخرى بفكِّ قيدِها ومنحِها شرفَ الحرية. - في كفارةِ الظِّهار: قال سبحانه:
{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3].
هنا أطلقَ القرآنُ لفظَ الرقبةِ ولم يقل “مؤمنة”؛ فكان أيُّ عتقٍ كافياً لتكفيرِ هذا الخطأ القولي.
وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة:
هل يُحمل مطلق الرقبة في الظهار على مقيدها في القتل، فتُشترط صفة الإيمان في الجميع، أم يُفرَّق لاختلاف السبب والسياق؟
فذهب جمهورهم إلى اعتبار سياق كل حكم بحسب علته، وعدم حمل أحدهما على الآخر لاختلاف الجناية واختلاف موجب الكفارة.
الشرحُ الميسر: القرآنُ هنا لا يتناقضُ، بل يُعلّمنا أنَّ “الجنايةَ على الأرواح” تتطلبُ شرطاً في الكفارةِ أعظمَ مما تتطلبُهُ “الجنايةُ بالأقوال”، فكلُّ حكمٍ جاء مفصلاً على قدرِ مقتضاه.
[انظر: المغني لابن قدامه المجموع للنووى
المثال الثاني: حدُّ السرقةِ (هيبةُ النصِّ ورحمةُ التطبيق)
بنى القرآنُ جداراً منيعاً لحمايةِ حقوقِ الناسِ وأموالهم، فقال بلسانِ الحزم:
{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38].
هذا النصُ مطلقٌ في اليد، واليدُ في اللغةِ تَمْتَدُّ من الأصابعِ إلى المَنْكِب.
فلو أُخِذَ النصُّ على ظاهرهِ المطلقِ لربما جارَ الناسُ في القطع.
ولكنَّ السُّنَّةَ النبويةَ كانت هي القيدَ الشارح، فقد ثبتَ عن النبي ﷺ – قولاً وعملاً – أنَّ القطعَ يكونُ من “الرُّسْغِ” (مفصل الكف لليد اليمنى)، وثبت ذلك بالسنة المتواترة في بيان موضع القطع.
المعنى بوضوح: القرآنُ ذكرَ “العقوبةَ” ليتحققَ الزجرُ، والنبي ﷺ حددَ “الموضعَ” ليتحققَ العدلُ والرحمة، فالقرآنُ يُشرِّعُ والسنةُ تُهذِّبُ طرائقَ الامتثال.
[انظر: المغني والمجموع]
المثال الثالث: تحريمُ الدمِ (بين عمومِ المنعِ ويسرِ الاستثناء)
نقرأ في سورةِ المائدةِ حكماً حازماً:
{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ…}.
فيبدو الدمُ كلُّه محرماً بجميعِ صورهِ.
لكنَّ القرآنَ الكريمَ في سورةِ الأنعامِ أرادَ أن يرفعَ الحرجَ عن الناس، فقيدَ هذا التحريمَ بقولهِ:
{أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا…} [الأنعام: 145].
الشرحُ البسيط: الدمُ المسفوحُ هو الذي يسيلُ بغزارةٍ عند الذبح، وهو الذي يحملُ الأذى. أما ما يبقى في العروقِ واللحمِ مما يصعبُ نزعُه، فقد أخرجهُ القيدُ (مسفوحاً) من دائرةِ الحرام. فالآيةُ الثانيةُ لم تُغير رأي الأولى، بل “نظمت” فهمنا لها، لنعرفَ ما نتركُ ورعاً وما نأكلُ يقيناً.
[انظر: تفسير ابن كثير الجامع لأحكام القرآن للقرطبى.]
المثال الرابع: فريضةُ الصيامِ (عزيمةُ الوجوبِ وسعةُ الرُّخصة)
يقررُ القرآنُ المبدأ العام في قوله:
{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185].
أمرٌ مطلقٌ لكلِ من حضرَ رمضان.
ثم في اللحظةِ ذاتها، يُعلمنا القرآنُ أنَّ هذا الدينَ ليس عناءً،
فيضعُ القيدَ الرحيم:
{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.
المعنى المباشر: الصيامُ حقُّ اللهِ المطلق، لكنَّ العذرَ قيدٌ يبيحُ الإفطار. فالقرآنُ لا يضربُ أحكامَهُ ببعض، بل يضعُ “الأصلَ” (الصيام) ويفتحُ “بابَ النجاة” (للمريض والمسافر)، لتكتملَ صورةُ الدينِ القائمِ على اليسر.
[انظر: المجموع للنووى
بداية المجتهد لابن رشد
المثال الخامس: الوصيةُ (حقُّ القريبِ وعدلُ الوارث)
حثَّ اللهُ المؤمنين على صلةِ الأرحامِ بالمالِ عند الرحيل، فقال:
{الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 180].
كان هذا الحكمُ مُطلقاً يشملُ كلَّ قريب، وارثاً كان أو غيرَ وارث.
ولكي لا يطغى حُبُّ قريبٍ على آخر، أو يُحرمَ الأبناءُ بسببِ ميلِ المتوفى لغيرهم، جاء القيدُ النبوي الحكيم:
«لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ».
وقد اختلف العلماء في توجيه العلاقة بين هذه الآية وآيات المواريث: فذهب جمهورهم إلى أن حكم الوصية للوارث قد نُسخ بآيات المواريث، بينما رأى آخرون أن الآية باقية في حق غير الوارثين، ويُحمل النهي النبوي على تقييدها لا على نسخها، جمعاً بين النصوص وإعمالاً لها جميعاً.
فصارَ العملُ بالآيةِ مقيداً بغيرِ الوارثين، ليبقى للوصيةِ دورُها في سدِّ خُلَّةِ المحتاجين، وللمواريثِ نظامُها في حفظِ بيوتِ المسلمين.
[انظر: المغني وبداية المجتهد
خاتمةُ القول
إنَّ “المُطلقَ والمُقيدَ” في القرآنِ ليس إلا دليلاً على أنَّ هذا الوحيَ من لدن حكيمٍ خبير؛ يضعُ القواعدَ لئلا يضلَّ الناس، ويضعُ القيودَ لئلا يطغى الناس. فلا تعارضَ في كتابِ الله، بل هو بنيانٌ مرصوص، يُفسِّرُ بَعضُه بَعضاً، ويأخذُ بَعضُه بحُجزةِ بَعض.
{كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ} [هود: 1].
تمهيد للحلقة الخامسة:
بعد أن أَبصرنا كيفَ يُحكِمُ القيدُ سعةَ المطلق، نضربُ موعداً في الحلقةِ القادمةِ مع (المُجْمَل والمُبَيَّن)؛ لنكتشفَ كيف يطوي القرآنُ المعانيَ العظيمةَ في كلماتٍ يسيرة، ثم ينشرُ تفاصيلَها في مواضعَ أخرى لتستبينَ سبيلُ المؤمنين.
وللبيانِ بقية…