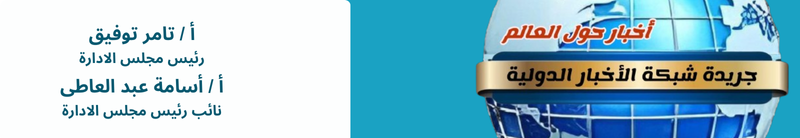إن النفس لأمارة بالسوء
بقلم / محمـــد الدكـــروري
الحمد لله برحمته إهتدى المهتدون، وبعدله وحكمته ضلّ الضالون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، تركنا على محجّة بيضاء لا يزيغ عنها إلا أهل الأهواء والظنون، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثم أما بعد لقد أقسم الله سبحانه وتعالى بالنفس الإنسانية لأنها أعظم ما خلق وأبدع، أما أحوال النفس التي عرضها القرآن الكريم فهي النفس الأمارة بالسوء وهي النفس التي تأمر الإنسان بفعل السيئات والتي أخبر عنها القرآن الكريم في قوله تعالى ” وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم ” فهي تأمر صاحبها بفعل كل رذيلة، تسيطر عليها الدوافع الغريزية، وتتمثل فيها الصفات الحيوانية.
وتبرز فيها الدوافع الشريرة، فهي توجه صاحبها بما تهواه من شهوات، وأخبر سبحانه وتعالى عن تلك النفس أنها أمارة بصيغة المبالغة، وليست آمرة لكثرة ما تأمر بالسوء، ولأن ميلها للشهوات والمطامع صار عادة فيها إلا إن رحمها الله عز وجل وهداها رشدها، وأيضا النفس اللوامة وهي التي أقسم بها الله تعالى في القرآن الكريم فقال تعالى ” ولا أقسم بالنفس اللوامه ” فاللوامة نفس متيقظة تقية خائفة متوجسة، تندم بعد إرتكاب المعاصي والذنوب فتلوم نفسها، تبرز فيها قوة الضمير فتحاسب نفسها أولا بأول، وهذه كريمة على الله، لذلك أقسم بها في القرآن، ومن أحسن الأقوال عن النفس اللوامة قول إمام التابعين الحسن البصري رضي الله عنه “إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه ما أردت بكلمتي؟ ما أردت بأكلتي؟ ما أردت بحديث نفسي؟ وإن الفاجر يمضي قدما ما يعاتب نفسه”
وأيضا النفس المطمئنة وهي التي اطمأنت إلى خالقها، واطمأنت في بسط الرزق وقبضه وفي المنع والعطاء، وهي النفس المؤمنة التي إستوعبت قدرة الله، وتبلور فيها الإيمان العميق والثقة بالغيب، لا يستفزها خوف ولا حزن، لأنها سكنت إلى الله وإطمأنت بذكره وأنست بقربه فهي آمنة مطمئنة، تحس بالإستقرار النفسي والصحة النفسية، والشعور الإيجابي بالسعادة، رضيت بما أوتيت ورضي الله عنها فحق لها أن يخاطبها رب العالمين بقوله تعالى ” يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلي ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ” وهي نفس تمسّكت بالحق وسارت عليه هدى ونبراسا لها في شؤون الحياة على الأرض، ولا يمكن حصول الطمأنينة الحقيقية إلا بالله وذكره كما قال تعالى ” ألا بذكر الله تطمئن القلوب ” فإن طمأنينة القلب سكينة وإستقرار بزوال القلق.
والإنزعاج والإضطراب عنه، وهذا لا يتأتى بشيء سوى بالله تعالى وذكره، ولقد أقسم الله سبحانه وتعالى بالنفس الإنسانية لأنها أعظم ما خلق وأبدع، والنفس البشرية كائن حي يتطور ويتغير، ولذلك يجب أن نغيّره بإتجاه الأفضل، وينبغي أن نعلم أن التغيير يبدأ من الداخل، وعلينا أن نحفظ القانون الإلهي في التغيير والمتمثل في قوله تعالى ” إن الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم ” فالنفس قد تكون تارة أمارة وتارة لوّامة وتارة مطمئنة في اليوم الواحد، بل في الساعة الواحدة يحصل لها هذا وذاك، لذلك كانت تزكية النفس وتنميتها من أهم الضرورات لأن بتزكيتها يكون الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة، وبإهمال التزكية تكون الخيبة والخسارة، فقال تعالى ” قد أفلح من تزكى وذكر إسم ربه فصلي ” لذا كانت إحدى المهام التي بعث الله تعالي الرسل من أجلها.
فكانت دعوة نبي الله إبراهيم عليه السلام ” ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ” وقد إستجاب الله تعالي لدعوته فبعث لنا حبيبنا المصطفي محمد صلي الله عليه وسلم ليقوم بهذه المهمة، ولكنه سبحانه قدّم التزكية على العلم، كما جاء في كتابه الكريم، فالتزكية قبل العلم لأن التزكية تطهر القلب حتى يكون مؤهلا لتقبل العلم والعمل به، وحينها لن يحول بينه وبين الهداية قواطع وموانع، وآفات النفوس كالكبر والعجب تقطع على المرء طريقه إلى الهداية، مما يؤدي إلى إعوجاجه وتوقفه عن العمل، ولكن التزكية تحرر النفس من تلك الآفات وتجعله ينتفع بما يتعلم فلا ينبغي أن تقدم شيئا على تزكية نفسك ومعرفة عيوبها والشروع في إصلاحها، وبالتزكية يتحقق القلب بالتوحيد والإخلاص.
ويصل للمنازل العالية من الصبر والشكر والخوف والرجاء والمحبة لله سبحانه وتعالى والصدق مع الله، ويتخلى عن الرياء والعجب والغرور والغضب وغيرها من آفات النفوس، ولقد كان السلف الصالح يولون أمر تزكية النفس وتطهير القلب إهتماما بالغا، ويقدمونها على سائر الأمور فكيف نزكي أنفسنا؟