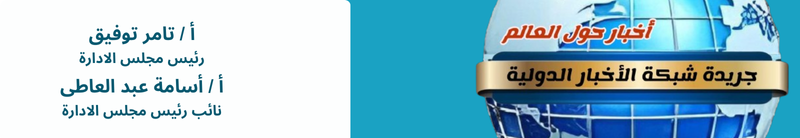بقلم / محمـــد الدكـــروري
ذكرت المصادر الإسلامية الكثير أن لقمان الحكيم قال لابنه يا بني، لا تؤخر التوبة، فإن الموت يأتي بغتة، ومن ترك المبادرة إلى التوبة بالتسويف، كان بين خطرين عظيمين، أحدهما أن تتراكم الظلمة على قلبه من المعاصي، حتى يصير رينا وطبعا فلا يقبل المحو، الثاني أن يعاجله المرض أو الموت فلا يجد مهلة للاشتغال بالمحو، وعن أبي إسحاق قال قيل لرجل من عبد القيس في مرضه أوصنا قال أنذرتكم سوف، وأوصى ثمامة بن بجاد السلمي قومه، فقال أي قوم، أنذرتكم سوف أعمل، سوف أصلي، سوف أصوم، ويقول الحسن البصري رحمه الله إياك والتسويف، فانك بيومك، ولست بغدك، قال فإن يكن غد لك، فاعمل عملا تكون به كيسا وإلا يكن الغد لك، لم تندم على ما فرطت في اليوم، وكان مالك بن دينار يقول لنفسه ويحك، بادري قبل أن يأتيك الأمر.
ويحك بادري قبل أن يأتيك الأمر حتى كرر ذلك ستين مرة، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله” قالوا كيف يستعمله؟ قال ” يوفقه لعمل صالح قبل موته ” رواه الإمام أحمد والترمذي، وإن من العجيب أن أبصر الناس بفن القول، وأهل النبوغ في الأداء، ويعرفون القول الفصل، والرأي الصحيح، ويميزون بين فنون القول خطابة وكتابة، ونثرا وشعرا، والقول المسجوع، والقول المرسل من العجيب أنهم يقفون أمام معجزة القرآن مبهوتين لا يعرفون من أمرهم رشدا، فمرة يقولون إنه سحر، ومرة يقولون إنه كلام كهنة، وثالثة يقولون إنه كلام مجنون، والقرآن ليس بسحر لأنه يملك من البيان ما يملكون، وفوق ما يملكون ويحسنون، ولا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم ما يجعلهم يؤمنون على الرغم منهم.
وليس القرآن كذلك بكلام كهنة لأن رسول الله نشأ بينهم، ويعلمون أنه الصادق الأمين، الذي لم يتلقي علما من أحد، ولقد أعد الله سبحانه وتعالي رسوله الكريم المصطفي صلي الله عليه وسلم ليستقبل النبوة بقوة العقل، لا بسفه الرأي، وله في إبلاغ رسالة ربه ثواب لا مقطوع ولا ممنوع، وهو على الخُلق العظيم، والخلق العظيم هو استقبال الأحداث بملكات متساوية وليست متعارضة، ولا يملك ذلك إلا عاقل، وقد شهدوا هم بخُلق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فكيف يأتي هذا القرآن من مجنون؟ إذن فهذا القرآن الكريم، كما حكم الحق سبحانه فقال إنه ” لا ريب فيه” ولم يقوم بتأليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي به من عند نفسه بل هو وحي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم النبي الأمي، الذي لم تَخط يده كتابا، ولم يقل شعرا، ولم يعرف بخطابة ولا نثر، ولا غيره من فنون القول عند العرب.
لذلك كان ذلك الكتاب لا ريب فيه، إذن فالأمية شرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه أمي، ولأن الله قد بعثه رسولا فكل ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته فهو معجز لأنه قادم من أعلى، وهكذا كان اختيار الله عز وجل لرسول صلى الله عليه وسلم أمي، حتى تتأكد صلة السماء بالأرض، بما لا دخل لأهل الأرض به في رسالته التي تهديهم إلى ما تريده السماء، ولهذا نرى أن الأمّيين عندما آمنوا بالرسالة التي نزلت على الرسول الأمي، كانت لهم قدرة الإقناع، وكان منطق انتشار الإسلام يبدأ من منطق أنه لا سيادة لمخلوق على مخلوق إنما سيادة الإنسان في الكون نابعة من خضوع الجميع لله الأعلى، ولكن ما السبيل إلى تطهير النفس من الكبر والغرور والخيلاء؟ وهل من علاج لهذا الداء الذي يعاني منه كثير من الناس؟ وهو يجب أن نعلم أن الكبر خلق ذميم، يبغضه الله ورسوله.
ويبغضه كل صاحب عقل سليم وفطرة نقية، وهو خلق سيء لا يليق بإنسان عاقل، فضلا عن مسلم يرجو لقاء ربه والدار الآخرة، فكيف تتكبر على الله، وهو خالقك ورازقك؟ وتتكبر على عبادة ربك، وقد خلقت من أجلها، وفيها فلاحك ونجاتك وسعادتك؟ وفي تكبرك على عبادة الله هلاكك وخسرانك؟ وكيف تتكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قد جاءك بهذا الدين العظيم، والقرآن الكريم الذي أنقذك الله به من الكفر إلى الإيمان، وأخرجك به من الظلمات إلى النور؟